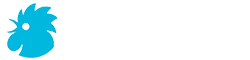نُسلّط الضوء على فنّانين استلهموا من تنوع الأرض وجمالها لوحاتٍ ونصوصٍ وأصواتٍ تنسج جسوراً بين التاريخ والحاضر. من الرسّامين الذين يرسمون الأرز على قماشتهم بألوان الفجر، إلى النحاتين الذين يحيون الحجر بحسّ معاصر، وإلى موسيقيين ينتجون ألحاناً تحمل عبق الأرز والشمس.
يفتح فنّانون في "عيش لبنان" أبواب ورشهم وأستوديوهاتهم، ويدعوننا لاكتشاف قصة كل قطعة فنية وكيف تحاكي هوية المكان وتسرد حكايات القرى والجبال والشواطئ.

"ميّاس"
حين يرقص لبنان ليحيا

من قلب لبنان المتعب، ولدت فرقة "ميّاس" لتُعيد تشكيل صورة الوطن على مسارح العالم، ولترسم بالجسد ما عجزت عنه الكلمات والخطب والخطط. فمن "America's Got Talent" إلى افتتاح مهرجانات الأرز، ومن عروض بيروت إلى منصة بيونسيه في دبي، خطّت "ميّاس" مساراً غير مألوف لفرقة لبنانية نسائية، صنعته بالإرادة، والانضباط، والإبداع الذي لا يشبه إلا ذاته.
تأسّست الفرقة عام 2019 على يد نديم شرفان، الفنان الذي جعل من الرقص مشروع حياة ورسالة وطن. الراقصات في الفرقة، بعضهنّ لاجئات من الحرب، وبعضهنّ طالبات فن، وجميعهنّ اجتمعن تحت مظلة واحدة: تحويل الرقص إلى لغةٍ عالمية تعبّر عن لبنان بجماله، وتاريخه، وهشاشته، وتمرده، وموسيقاه، وصراخه، وأمله.
عام 2022، فازت "ميّاس" بلقب برنامج "America’s Got Talent"، في لحظة مفصلية جعلت العالم يُصغي لصوت لبنان المختلف، الخارج من رحم الألم. "سأرقص دفاعاً عن لبنان العظيم"، كتب نديم شرفان، مستذكراً قسم جبران تويني. لم يكن الفوز مجرّد انتصار تقني، بل كان لحظة اعتراف بأنّ اللبناني قادر على تحويل المعاناة إلى فن، والخسارات إلى ضوء.
نديم شرفان، الآتي من قرطبا، لم يكن مجرّد مدرّب. هو راقصُ الحياة، وشاعرُ الحركة، وناقدُ النظام بصمت. عاش طفولةً مؤلمة، واجه فيها مرض والده، والفقر والخذلان، لكنه لم يتنازل عن الحلم. وجد في الجسد مساحة حقيقية للقول والتعبير، فأنشأ "ميّاس" كفرقة تُقاتل بالصمت والظلّ، وتنبض بالضوء والدقة.
اليوم، تواصل الفرقة مشوارها الفني باحتراف عالٍ. قدّمت عروضاً ساحرة في الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والإمارات، وشاركت في مناسبات عالمية إلى جانب أسماء كبرى كبيونسيه، كما أقامت ورش عمل ومشاريع فنية لتعزيز الفن الاستعراضي في لبنان والمنطقة.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، تُواصل "ميّاس" عملها من بيروت كقاعدة رئيسية للتدريب والإنتاج الفني، مما يشكّل تحدّياً وجودياً ورسالة وفاء للوطن. تعمل الفرقة على مشاريع، بعضها يتناول قضايا النساء، والهجرة، والهوية، من خلال عروض بصرية تمزج ما بين الفنون المعاصرة والتراث الشرقي.
اللافت في تجربة "ميّاس" أنّها لا تقدّم مجرّد استعراضات راقصة، بل أعمالاً مسرحية صامتة، مفعمة بالرمزية، تتّكئ على الإبهار البصري، والموسيقى المختارة بعناية، والتناسق الجسدي الذي يتحوّل إلى لغة قائمة بذاتها. كل عرض هو حكاية، وكل حركة هي جملة شعريّة.
حين افتتحت الفرقة "مهرجانات الأرز الدولية" في صيف 2025 بعرض "العودة"، المخصّص لجبران خليل جبران، أثبتت أنها قادرة على تحويل الرموز الثقافية إلى مادة إبداع حيّة، تُخاطب أجيالاً جديدة من اللبنانيين والعرب والعالم.
"ميّاس" ليست فقط فرقة فازت بلقب عالمي. هي مرآةٌ تُطلّ منها بيروت على العالم بثقة ودهشة.

بيروت في السرد البصريّ
لتوم يونغ
سفير بريطاني للبنان في العالم

الجميزة، بيروت. الطير ينسج جدران عشّه في كوّة داكنة، ويتأهّب لصيفٍ مثمر. صخب الشارع يزيد المدينة حياةً، وأبواق السيارات تكاد ألا تستكين. الشارع مزدان بالزهور والأشجار والضحكات؛ فضاؤه مفتوح على سماء تسمع حكاياتنا، ولقصصنا التي ربما لم نبُح بها.
في بناية أنيقة تحمل ملامح الزمن البيروتي القديم، محترف توم يونغ. مساحة تفيض بالألوان والأفكار، يمتزج فيها الشرق والغرب بصورة الرسام البريطاني، وتتناغم فيها الثقافات مع ألوان لوحاته. البيت البيروتي العتيق صورة للعلاقة الدقيقة بين العالمين: عالمه البريطاني، ولبنان، البلد الذي يغفو على تاريخ عميق من أصوات وألوان وذكريات.
بلغة عربية تزيده "هضامةً"، مطعّمة بالإنكليزية البريطانية، يستقبل توم يونغ زائريه الفضوليّين. الباب الخشبي الأبيض يُفضي إلى عالم مزخرف بالأصباغ الزاهية. حتّى في أشدّ اللوحات قتامةً، ألوانه زاهية. يستعيد محطّاته في بيروت التي حلّ فيها قبل زمن. يبتسم لكلّ ما مرّ به هنا، المرّ والحلو والأحلى. لكلّ منّا حكاياته الخرافية مع بيروت؛ تلك الحكايا التي نكاد ألا نصدّقها. حكايا الحب، والدمع، والأقدار التي تتلاعب بنا ولا نقوى على عنادها.
لا يرسم توم يونغ في بيروت ما تراه العين المجردة، بل يرسم ما يعيشه وما يشعر به. في محترفه، تنعتق اللوحة من إطارها المادي، وتظهر انعكاساً حقيقياً لتجربة حياة تمتزج فيها رؤاه مع روح المدينة. يُدرك جيّداً كيف يلتقط اللحظات الدقيقة التي لا تلتقطها الكاميرات، ويتوسّل بضربات فرشاة ليوثّقها.

بيروت توم يونغ تتعدّى الحيّز الجغرافي نحو حالة من الاندماج والتشابك بين الذات والأرض والتاريخ. لا ينظر إليها بأعين كثيرين ممّن عرفوها، بل يراها متاهة من الألوان والظلال، في كلّ زاوية قصة، وكلّ عنصر يتحدّث عن حالة نفسية. الشوارع القديمة، حيث تتناثر بقايا الزمن الجميل، تنبض في لوحاته، فتخلق مشهداً بصرياً يروي صراع الإنسان مع المكان والزمان.
في أعماله عمق يكتسبه عبر تداخل العناصر. ثمّة إشارات ورموز يكاد أن يراها قليلون تكشف عن قصص المدينة. في كلّ لوحة، هناك تلك اللحظة السحرية حيث الخط الفاصل بين الشرق والغرب. كلّ حركة على القماش تنبع من سعي الفنان الى فهم ذاته في عالم غريب وغير ثابت، بينما يدرك تماماً أن بيروت، بكل ما تحمله من تناقضات وأصوات، مشهد مفتوح يحتوي على كلّ تباين في الثقافة والحياة.

يعكف توم على التقاط الإشارات والإيماءات البيروتية، خلال ساعات طوال في محترفه، حيث تختلط أصوات الشارع بأصواته الداخلية. يفكر في التفاصيل الدقيقة للمدينة؛ في شوارعها الضيقة التي تحتفظ بذكريات قديمة، وفي معمارها الذي يعكس التقاليد والحداثة. بيروت، بشوارعها المتشابكة، مرآة لعالم توم يونغ الخاص، الذي يتنقل بينه وبين واقعه، يبحث عن معان جديدة في اللحظات اليومية.
هنا الحياة جميلة، وفيها شيء من البساطة الأنيقة، الغنية بتفاصيله الصغيرة. يريد أن يرسم ما يشعر به، أن يترجم أحاسيسه وأفكاره ورؤاه، ليصحّح سرديّات الإعلام الأجنبي التي تنحرف نحو تشويه سمعة وطن ومدينة. نقول له إنّه أشبه بسفير أجنبي للبنان في العالم، فيضحك.
بين بيروت التي حطّ فيها لأول مرة، وتلك التي يرسمها اليوم، مسافة من التحوّل والخذلان والانبهار. تغيّرت المدينة، وغيّرته. صار يعرف أنها لا تمنحنا أسرارها دفعة واحدة، لكنها لا تكفّ عن إبهارنا

"محترف عسّاف"
في الشوف
عندما يحكي الحجر

خلال الجولة، يشدك المشهد الأخضر المحيط بالمكان، حيث تنتشر الأشجار وعليها بطاقات تعريفية بأسمائها العلمية والمحلية، مزوّدة برموز QR لتعرّف الزوار أكثر إلى هذا التراث الطبيعي. القيقب، السنديان، الملّول، الحمبلاس وغيرها من الأصناف التي تشكّل ذاكرة الغابة اللبنانية، وجدت لنفسها مكاناً محفوظاً هنا.
على المقلب الآخر من المقام مغارة صغيرة ينير داخلها المؤمنون الشموع، وعلى هذه المغارة لافتة معلقة كتب عليها باللغة البنغالية، وحينما يسأل أحد المسؤولين عن المقام عن سبب هذه الكتابة، يشير إلى أن زوار المقام "ليسوا فقط لبنانيين أو عرب، بل من كافة الجنسيات، وخصوصاً الهندية والبنغالية"، ويستقبل المقام بشكل دوري مجموعات من دول آسيا الوسطى.
يمين المغارة نبعة مياه، يقال عنها مياه مباركة تفجّرت تحت أقدام النبي أيوب يشرب منها الزائرون والمؤمنون.
عاينت "النهار" هذا المعلم الديني – السياحي، وقد كان في الاستقبال رئيس مصلحة الشوؤن التربوية والدينية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز فاضل سليم وعدد من المشايخ، الذين رووا بعض التفاصيل عن هذا المقام التاريخي والاستثنائي عند الموحدين الدروز والناس بشكل عام، وقالوا لـ"النهار" إن زوّار هذا المقام من كافة الأديان المذاهب والجسنيات، يزورونه "ليستلهموا من قصة النبي أيوب وصبره على الابتلاء".
على تلة مطلّة على بساتين الشوف وأشجار السنديان والملول، ينبض "محترف عساف" بروح فريدة تربط الفن بالطبيعة والثقافة. هنا، لا تدخل مجرد ورشة للنحت، بل فضاءً مفتوح يعيد تعريف علاقتنا بالحجر والشجر معاً، ويحوّل الذاكرة إلى منحوتات حيّة تحاكي أجيالاً.
أسّس هذا المشروع ثلاثة إخوة: عساف ومنصور وعارف عساف، أبناء عائلة عريقة في العمارة والنحت، استمدّوا شغفهم من والدهم الذي كان معمارياً ونحاتاً ومزارعاً في الوقت نفسه.
يروي منصور عساف خلال جولة معه في المحترف أن البذرة الأولى للمشروع زُرعت عام 1997، عندما اجتمع الإخوة على حلم مشترك يجمع الطبيعة بالفن، قبل أن ينطلق رسمياً عام 2016 تحت اسم "محترف عساف".
"أول شيء هو الطبيعة"، هكذا بدأ منصور عساف كلامه بحماسة، مؤكداً أن الطبيعة هي الملهم الأول والأساس لكل ما يقومون به. فهنا، تحضر ثقافة العمارة البيئية والعيش المستدام، احترام البيئة والأرض، لتمنح الفن معنى أعمق من مجرد أشكال جميلة.
يدير المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز هذا الموقع ويهتم بشؤونه وعمليات ترميمه وفق ما يشير سليم، وقد أدرجه مجلس الوزراء على قائمة المواقع السياحية الدينية.
قصة النبي أيوب الملهمة تدفع بالمؤمنين إلى زيارة المقام، والعبرة منها تبث فيهم روح الصبر، يرويها سليم لـ"النهار" بجلسة عند الباحة الأولى بعد القنطرة، فيقول إن النبي أيوب كان من منطقة حوران السورية، يتمتع بحياة مليئة بالصحة والمال والرزق والأبناء والأصدقاء، ويقال أنّه عاش لأكثر من 40 عاماً في هذه الحالة، لكنه كان يعتبر هذه الحياة اختباراً له، وحسب الرواية، فإنه كان يساعد الفقراء والمحتاجين.
المنعطف في حياة النبي أيوب كان ابتلاءه بالمرض الشديد وفقر الحال وهجر الأحباب، وقد انتقل إلى نيحا خلال فترة مرضه، وكانت زوجته تحاول مساعدته دون جدوى. صبر على الألم وعلى تبدّل الحال، وكانت عبارته الدائمة "رزقني الله 40 عاماً، فلا أصبر على الألم 7 أعوام؟" وفق ما ينقل سليم، وحينما اشتد الابتلاء، خاطب ربّه، فقال له "إن مسني الضر، وأنت أرحم الراحمين"، وهي المفارقة التي يتوقف عندها سليم، فيقول إن "الناس تطلب من الله بصيغة الأمر، افعل هذا يا الله وحقق لي ذاك، فيما أيوب ناجا ربه بصيغة طلب الرحمة".
ووفق الرواية، يقال إن الله أهدى النبي أيوب ليضرب بالأرض فيتفجّر ينبوع يشرب منه فيشفى، وتعود زوجته من سفر طويل فلا تعرفه بعد تبدّل حاله وعودة عافيته، ويقول سليم: "سألت الزوجة أيوب عن أيوب، لأنها لم تعرفه".
يروي المسؤولون عن هذا المقام الرواية والعبرة بعدها، ويقولوا إن النعم اختبار والابتلاء اختبار، والصبر والتوكّل مفتاح كل اختبار وفرج، ولهذا السبب يزوره الكثير من المؤمنين الذين يشعرون بضيق أو يعانون من أزمة، فيلهمهم النبي أيوب بالصبر.
يدير المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز هذا الموقع ويهتم بشؤونه وعمليات ترميمه وفق ما يشير سليم، وقد أدرجه مجلس الوزراء على قائمة المواقع السياحية الدينية.
قصة النبي أيوب الملهمة تدفع بالمؤمنين إلى زيارة المقام، والعبرة منها تبث فيهم روح الصبر، يرويها سليم لـ"النهار" بجلسة عند الباحة الأولى بعد القنطرة، فيقول إن النبي أيوب كان من منطقة حوران السورية، يتمتع بحياة مليئة بالصحة والمال والرزق والأبناء والأصدقاء، ويقال أنّه عاش لأكثر من 40 عاماً في هذه الحالة، لكنه كان يعتبر هذه الحياة اختباراً له، وحسب الرواية، فإنه كان يساعد الفقراء والمحتاجين.
المنعطف في حياة النبي أيوب كان ابتلاءه بالمرض الشديد وفقر الحال وهجر الأحباب، وقد انتقل إلى نيحا خلال فترة مرضه، وكانت زوجته تحاول مساعدته دون جدوى. صبر على الألم وعلى تبدّل الحال، وكانت عبارته الدائمة "رزقني الله 40 عاماً، فلا أصبر على الألم 7 أعوام؟" وفق ما ينقل سليم، وحينما اشتد الابتلاء، خاطب ربّه، فقال له "إن مسني الضر، وأنت أرحم الراحمين"، وهي المفارقة التي يتوقف عندها سليم، فيقول إن "الناس تطلب من الله بصيغة الأمر، افعل هذا يا الله وحقق لي ذاك، فيما أيوب ناجا ربه بصيغة طلب الرحمة".
ووفق الرواية، يقال إن الله أهدى النبي أيوب ليضرب بالأرض فيتفجّر ينبوع يشرب منه فيشفى، وتعود زوجته من سفر طويل فلا تعرفه بعد تبدّل حاله وعودة عافيته، ويقول سليم: "سألت الزوجة أيوب عن أيوب، لأنها لم تعرفه".
يروي المسؤولون عن هذا المقام الرواية والعبرة بعدها، ويقولوا إن النعم اختبار والابتلاء اختبار، والصبر والتوكّل مفتاح كل اختبار وفرج، ولهذا السبب يزوره الكثير من المؤمنين الذين يشعرون بضيق أو يعانون من أزمة، فيلهمهم النبي أيوب بالصبر.

رحلة إلى "Domaine"
رودي رحمة
محترَف يحرس جمال لبنان

ها هو رودي، بين تمثالٍ مكتمل الملامح ووجهٍ يولد من الرخام. عيناه تسرحان في ما لم يولد بعد. أصابعه تحمل صلابة الجبل وليونة القصيدة. يُمسك المطرقة كما يُمسك شاعرٌ قلمَه عندما يكتب عن وطنٍ يحترق ولا يموت.
يمرّ بقربنا تمثالٌ تلو الآخر، أطياف نسّاك خرجت للتو من صلاةٍ طويلة، وخلفها وجه أمٍ شهقت ذات حرب وشاءت أن تبقى واقفة، تشبه لبنان. تماثيل تحكي، تهمس، تلمسنا بصمتها. مرّة جديدة، إنّه الصمت الأنيق. كلّ تفصيل في هذا "الدومين" يقول شيئاً عن شعبٍ يسقط، لكنه يعرف كيف ينهض، وعن فنانٍ يحفر صمودنا في عين الزمن.
بقعة هادئة وسط وادي نهر الكلب. الجبال ترتفع شامخةً لتلامس الغيم، والضوضاء تنسحب كأنها لم تكن. هناك، يمتدّ واسعاً "دومين رودي رحمة" (Domaine Rudy Rahme) في امتداد حالمٍ للبنان الذي لم ينكسر، لبنان ذي الوجوه المقدّسة، والوطن الذي يتماهى بملامح انتصاره مع رجل نحت من ألمه جمالاً.
تعالوا معنا، بهدوء وصمت يُحاكي صمت الطبيعة وسكونها الأنيق، إلى هذا المكان المسكون بالضوء والرجاء. البوابة الخشبية المطعّمة بالحديد الصلب لن تُفتح أمامكم على مرسم كسواه، بل على وطنٍ مصغّرٍ منحوت من الحجر والخشب والبرونز والقصيدة. لا ضجيج هنا سوى وقع الخطى على الأرض التي تعرف أصدقاءها، وتنهيدة الشجر القديم، وأسرار الإزميل على أخاديد الحجر.
في الطرف الآخر محترف الشعر. أوراق متناثرة، وقصائد بعضها لم يكتمل. رائحة الحبر تختلط بالخشب. رودي ينحت باليد وبالكلمة؛ ولبنان في وعيه وإدراكه قصيدة، وحواسه تشعر بالوطن وتروي فصولاً. ووسط المبنى تمتدّ الأشجار والأزهار والضوء، والطبيعة أيضاً تكتب شعراً. في الأفق، قباب الكنائس والأشجار الباسقة، وفي القلب، خفقةٌ لا تهدأ: لبنان كما يراه رودي، ليس كما هو، بل كما يجب أن يكون.
هكذا إذن، ندخل قلب فنان، ونخرج من قلب وطن. "دومين رودي رحمة" محترف للنحت والرسم والشعر... وأكثر. إنّه نداءٌ دائم ألا ننسى أنّ لبنان الحالم ما زال موجوداً، ما زال يعاند ويفتح يديه للإنسان بكلّ تناقضاته، وما زال يُخلق كلّ يوم، بين قصيدة وإزميل.

أرشيف الحنين
فيليب جبر يحكي لبنان بالصورة والحلم


حمل فيليب جبر لبنان معه إلى أصقاع الدنيا، كغصّةٍ لا تهدأ وحنين لا يبرد. أربعون عاماً من الغربة، بين نيويورك وباريس وجنيف، لم تُطفئ فيه الشغف بوطنٍ أحبّه كما يُحبّ الإنسانُ بلاده الأولى... بعنف، وبلا شروط. لم يُغره المجد المهني وحده، بل ظلّ يبحث عن وجه لبنان الجميل بين الأزمنة، جامعاً فتات ذاكرته، قطعةً قطعة.
واليوم، في ركنٍ هادئ من المتحف الوطني في بيروت، يُعرض جزءٌ من مجموعته الواسعة عن ملصقات السفر في "جناح نهاد سعيد للثقافة". هناك، لا تكتفي الملصقات القديمة بأن تُزيّن الجدران... بل تهمس كأنها أرواحٌ تعود من حقبة مجيدة، تروي حكاية بلدٍ يُلقَّب بـ"سويسرا الشرق". من عشرينيات القرن الماضي حتى سبعينياته، يمتدّ هذا الأرشيف البصري الذي لا يُقدَّر بثمن، لأنه ليس مجرد مجموعة فنية... بل نبض حنينٍ صامت، كتبه جبر عبر الصور كي لا يُنسى لبنان.
وعن طريق الحجز في المتحف الذي يملكه في بيت شباب، يمكن رؤية آلاف اللوحات والرسوم والصور وغيرها.
ولد فيليب جبر عام 1960 في بيروت، في زمنٍ كان فيه لبنان لا يزال يعزف سيمفونية الحياة بجمالها وفرادتها. وعندما بلغ السادسة عشرة، حمله القدر بعيداً... إلى عالمٍ آخر، إلى مناخات مغايرة، لكنّه حمل معه صورة لبنان كما أحبّه، وقرّر أن يُعيد رسمها، قطعةً قطعة، في كلّ ما أنجزه في غربته الطويلة.
فيليب، الذي تلقّى علومه بين لبنان وكندا وأميركا، كان يرى أن الهجرة تصهر البشر في قالب المساواة. "في الغربة، لا امتيازات لأحد. كلّنا نبدأ من الصفر"، يقول. لكن رغم نجاحاته التي لاحقته من نيويورك إلى جنيف، بقي الحنين إلى لبنان جمرة تحت جلده لا تبرد.
الفنّ بلغة الوطن
"التاجر المحظوظ هو من يجمع ربما لوحات بيكاسو، ثم يشهد سوقها طفرة. لكن لو لم يكن يجمعها بحبّ، لما استفاد منها"... بهذه البساطة يروي جبر شغفه بالفن. لكنه لم يجمع من أجل الربح، بل من أجل الذاكرة. من أجل لبنان الذي أراده أن يبقى حيّاً، لا فقط في الصور، بل في وجدان الناس.
مجموعة جبر الفنّية ليست متحفاً. إنها شريط حياة. ملصقات سفر، وأفيشات أفلام، وإعلانات قديمة لشركة طيران الشرق الأوسط ووزارة السياحة، تحكي عن زمنٍ كان فيه لبنان مقصد الحالمين. بيروت، بعلبك، جعيتا، البحر، الأرز، السهر... كلّها تطلّ من وراء الورق كأنها تقول: نحن هنا، لا تنسونا.
حينما عاد إلى فيلا العائلة في قرية "بوا دو بولون" أو "بولونيا"، كانت الجدران تصرخ من الألم. الفيلا التي احتلّها النظام الأمني السوري وتحوّلت إلى مقرّ مراقبة، بدت كأنها صورة مصغّرة عن الوطن الجريح. لكن فيليب لم يلتفت إلى الخراب، بل رأى فيها بذرة حياة. سبع سنوات من الترميم، أكثر من 10 ملايين دولار، و120 حرفياً أعادوا النبض إلى قلب من حجر. "أردت أن أقول إن لبنان يمكن أن ينهض"، يهمس.
واليوم، الفيلا، المحاطة بألف صنوبرة وياسمين وخزامى، تحتضن فنّاً وهدوءاً وصلاة.

ألمازة...
الجذور لا تموت

من المشاريع الأقرب إلى قلبه، كان تملّكه الغالبية في شركة "ألمازة"، معمل البيرة اللبناني التاريخي. لم يفعلها طمعاً بربح، بل رغبة في إعادة المؤسسة إلى حضن العائلة بعد تسعين عاماً. "ألمازة ليست مجرّد بيرة... إنها ذكرى"، يقول.
ومن جعيتا إلى القبيّات، ومن حفلات الصيف إلى دعم السياحة، لا يتردّد فيليب في القول: "بلدنا يجب أن يبقى منفتحاً على الخارج، ويجب أن يعود مقصداً للعالم".
ومنذ تأسيس "جمعية فيليب جبر الخيرية" عام 2001، تُمنح مئات المنح التعليمية والمساعدات الطبية والاجتماعية بصمت، من دون أضواء. "مساعدة الآخرين هي أهم نجاح يمكنك تحقيقه على الإطلاق"، قالها مرة، وبقيت تضيء الطريق.
يحب مساعدة الشباب، يؤمن بالعدالة الاجتماعية، ويؤكّد أن المجتمع لا يُبنى بالرواتب وحدها، بل بالثقافة والتعليم والكرامة.
وعلى رغم مسيرته المالية الباهرة، التي جعلته يُلقّب بـ"أسطورة صناديق التحوّط"، اختار البروفسور دكاش أن يمنحه لقباً آخر: "مبشّر التضامن الاجتماعي".
ربما لأن فيليب جبر يُشبه اللبناني الجميل، ذاك الذي لا يزال يؤمن بالحبّ والضوء والكرامة. رجلٌ يرى أن السياحة، والثقافة، والمؤسسات، كلها حلقات في سلسلة واحدة: "إذا مرض عضو من الجسد، يسقم الكلّ".
ولعلّه لهذا السبب بالذات، بقي جبر، رغم كلّ شيء، يحاول أن يُرمّم ما انكسر. أن يجمع ما تبعثر. أن يعيد رسم الوطن، من جديد، ملصقاً بعد ملصق... وحنيناً بعد حنين

كركلا
"ألف ليلة وليلة" من لبنان إلى مسارح العالم

من بعلبك، مدينة الشمس، خرجت فرقة كركلا لتُشكّل ظاهرة فنية ثقافية لا تشبه إلا نفسها، مزجت الشرق بالغرب، والرقص بالفكر، والمسرح بالحلم. عبد الحليم كركلا، مؤسس الفرقة، بنى مشروعه على ذاكرة شخصية متجذرة في الطبيعة والإرث، وعلى إيمان عميق بالقدر والالتزام، قائلاً: “إذا خالف الإنسان قدره، يصبح القدر ضدّه”، أما من يسير في طريقه “فيرضى عليه القدر ويعتبره من أبنائه”.
على مدى أكثر من خمسة عقود، قدّمت كركلا أعمالاً باتت علامات فارقة في المسرح الراقص العربي، منها:
“الأندلس عبق الحكاية”، "حلم ليلة شرق"، "إليسار ملكة قرطاج" وغيرها.
وشاركت في أهم المحافل والمسارح من “البيكاديلي” إلى “الأولمبيا”، ومن باريس إلى عمّان، ومن بعلبك إلى الدوحة، مرورًا بلندن، نيويورك، وبيكين...
وعادت الفرقة إلى واجهة المشهد الثقافي بعملها المرجعي: "ألف ليلة وليلة"، الذي أستعيد خلال ربيع 2025، في عرض مزج سحر الشرق مع لغة بصرية راقية: أزياء نابضة، إيقاعات تمتزج فيها الموسيقى الشرقية بالغربية، ولوحات راقصة تنبض بالحياة.
لكن المحطة الأهم بقيت العرض في مسرح البولشوي العريق في موسكو، حيث قدمت فرقة كركلا رائعتها ألف ليلة وليلة خلال تموز/ يوليو 2025.
ما يميّز فرقة كركلا ليس فقط ضخامة الإنتاج أو تنوّع المواضيع، بل الأسلوب الراقص الفريد الذي طوّرته عبر عقود، جامعاً بين تقنيات الباليه والكوريغرافيا الغربية وبين الإيقاعات الشرقية وحركات الدبكة اللبنانية.
ورغم العالمية التي وصلت إليها الفرقة، ظلّ لبنان هو القلب والنبض. أغلب عروض كركلا تنطلق من مرجعيات لبنانية أو تعود إليها: في الموسيقى، في الحكايات، في الزيّ، وحتى في طبيعة الحركة. ولبعلبك مكانة خاصة، فهي مهد الرؤية الأولى، ومن ضوء حجارتها وهدير وديانها وُلدت أحلام عبد الحليم كركلا