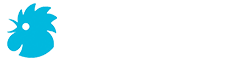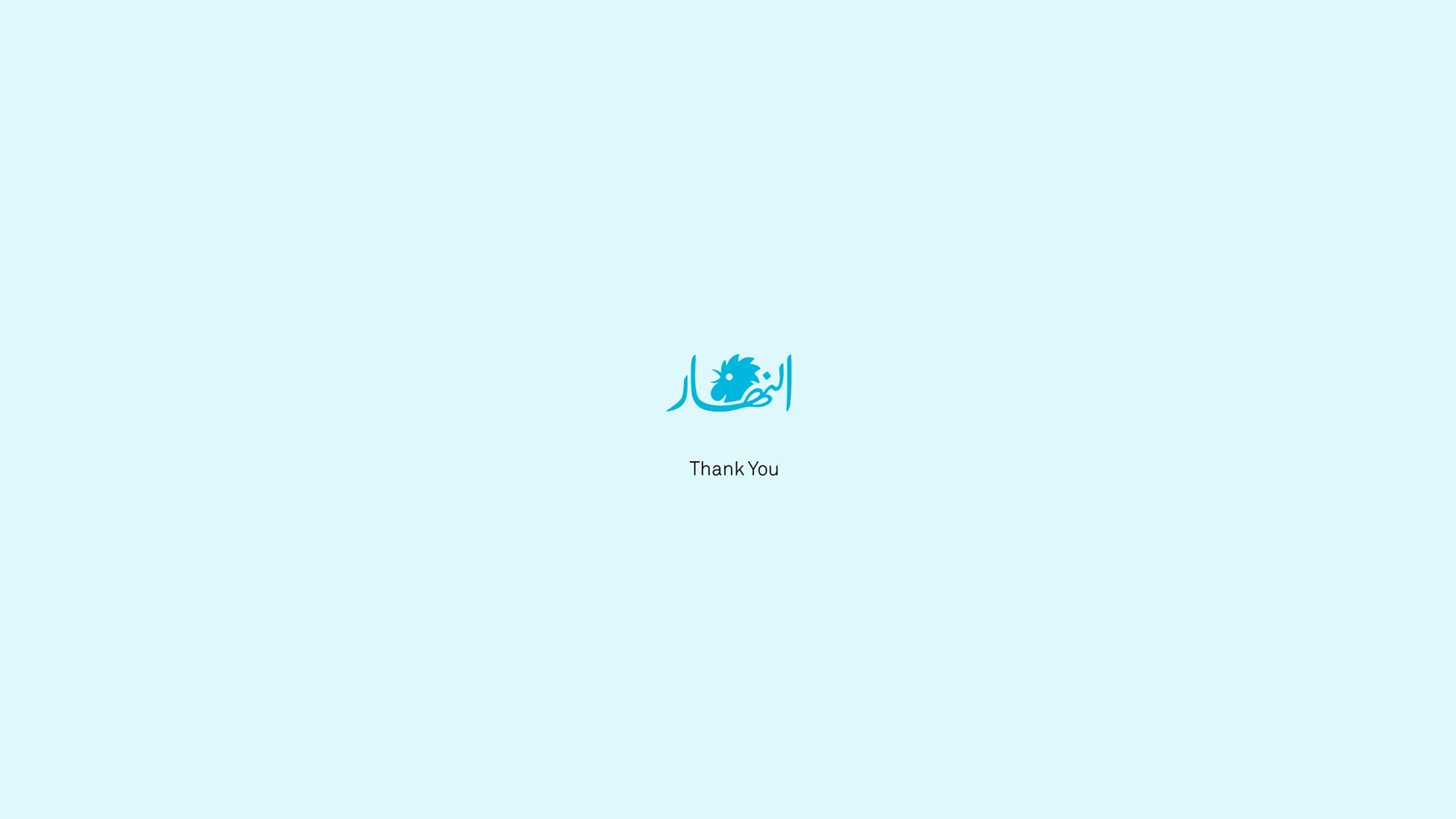في زوايا القرى وساحات الأسواق القديمة، لا تزال الأيادي تحفظ سرّ النار والطين والخيط والنحاس. في هذا المحور من "عيش لبنان"، نغوص في عالم المهن التقليدية التي شكّلت نبض الحياة اليومية في لبنان، ولاتزال تنبض بإبداعٍ صامد رغم تغيّر الزمن. من صوت المطرقة على النحاس في الأسواق العتيقة، إلى خيوط النول التي تحيك ذاكرة البيوت، ومن رائحة الصابون البلدي إلى دفء الفخار المشغول بحنان، تحكي هذه الحِرف قصص الناس، والبيوت، والأعياد.

صناعة الزجاج اليدوي في لبنان
عائلة خليفة تحافظ على إرث الأجداد
أحمد م. الزين

في المعمل، يعمل الجد والأب والأخوة معاً، وهم ثمانية أفراد، كل منهم يسهم في إبقاء هذه الحرفة حية في زمن تتقلص فيه الصناعات اليدوية في لبنان. وعن تأثير انفجار مرفأ بيروت، تقول نسرين: "كانت تجربة صعبة، لكننا تمكنا من تحويل الدمار إلى جمال"، مشيرة إلى جمع الزجاج المتناثر من أنقاض الانفجار وإعادة تدويره في المعمل.
العمل هنا لا يقتصر على تلبية الطلبات المحلية، بل يمتد ليشمل زبائن من الخارج أيضاً. تصل الطلبات من محلات الهدايا، والأعراس، والفعاليات التي تطلب القطع اليدوية التي لا يمكن أن تصنعها الآلات بسهولة. لذلك، يبقى الطلب مستمراً رغم طول فترة التصنيع.
توضح نسرين أن طبيعة العمل اليدوي تستدعي صنع كميات إضافية لتلافي الخسائر المحتملة: "إذا كانت هناك طلبية تتضمن 100 كأس ماء، فإننا ننتج نحو 120 كأساً احتياطياً، لأن بعض القطع قد تتعرض للكسر أو تظهر فيها عيوب أثناء التصنيع". وتضيف: "هذه العيوب، رغم أنها قد تبدو نقصاً، تضفي على القطع طابعاً إنسانياً فريداً لا يمكن تكراره في الزجاج المصنع آلياً".
يمثّل معمل نفخ الزجاج اليدوي لعائلة خليفة أكثر من مجرد مكان عمل. هو تراث حي يجمع بين الحرفة والصبر وروح العائلة، يحافظ على صناعة تقليدية تندر في لبنان، ويعكس قدرة الإنسان على تحدي الظروف وتحويل المادة الخام إلى فن ينبض بالحياة.
في بلدة الصرفند الجنوبية، تستمر عائلة خليفة في الحفاظ على حرفة نفخ الزجاج اليدوي التي توارثتها عبر أجيال. تدير المعمل حالياً نسرين خليفة التي تحدثت إلى "النهار" عن تفاصيل مهنة أصبحت نادرة في لبنان.
تشرح خليفة أن عملية صنع الزجاج اليدوي ليست سهلة، فهي تحتاج إلى سنوات طويلة من التدريب. وتقول: "إذا بدأ الشخص وهو في عمر 12 سنة، يحتاج إلى نحو 12 سنة ليصل إلى مستوى يمكنه فيه نفخ الزجاج بطريقة محترفة".
وتضيف أن الفرن المستخدم في المعمل يجب أن يصل إلى حرارة 1400درجة مئوية، ويأخذ 24 ساعة ليحترق تماماً، ثم يتطلب فترة تبريد تمتد لـ15 يوماً قبل إعادة استخدامه، وهذا يفرض على العائلة تنظيم عملها بحذر شديد.
المعرفة الفنية ليست كل شيء في هذا العمل، بل للصبر والدقة دور كبير. بعد نفخ كل قطعة زجاج، توضح نسرين: "توضع القطعة على المشواة لتبرد ببطء وبمراحل مختلفة من درجات الحرارة، لأن التبريد المفاجئ قد يؤدي إلى تشقق القطعة أو كسرها". لهذا السبب، تستغرق صناعة قطعة واحدة ساعات عدة قبل أن تكون جاهزة للتسليم.
تعتمد عائلة خليفة على إعادة تدوير الزجاج المستخدم والمتحطم، إذ تجمع عبوات الماء، وزجاجات البيرة والنبيذ، بالإضافة إلى قطع الزجاج المكسورة والمتناثرة. تقول نسرين: "الألوان التي نستخدمها تأتي من العبوات القديمة التي نعيد تذويبها وصنعها من جديد". ويتميز الزجاج اليدوي في المعمل بحمله للعيوب الطبيعية التي تنتج من العمل اليدوي، ما يجعل كل قطعة فريدة وتمتلك طابعها الخاص.
مهنة عتيقة تصونها يد امرأة
حكاية نحاس لا يصدأ
جاد فقيه

وسط عالم يتخلى شيئاً فشيئاً عن الصناعات اليدوية والصناعات المحلية، رفضت الأخيرة أن تكون المهنة مجرّد ذكرى. تحفر بأناملها الحكايات على الصواني والكؤوس والمباخر وصحون النرجيلة أكثر المنتجات مبيعاً في الآونة الأخيرة.
لم تكن الطريق سهلة. في بيئة يندر فيها أن تمتهن النساء الحِرَف الثقيلة، واجهت انتقادات، لكنها أصرّت. اليوم، يزورها الزوّار من لبنان والخارج، لشراء النحاس المحلي عوضاً عن البضاعة المستوردة المصنعة بماكينات حديثة وبمواد لا علاقة لها بالنحاس.
في شرحها عن المهنة تصر طرطوسي على فكرة أن المهنة التي امتهنتها منذ 40 سنة، كانت ولا تزال هواية بكل ما للكلمة من معنى وتقول: "لم يكن لدى والدي شاب لكي يرث هذه المهنة، فنحن 4 نساء، عادة الذكر هو من يرث المهن اليدوية العائلية، لكني أصررت على تعلمها وشجعت أخواتي الثلاث فأصبحنا فريق عمل متكاملاً".
وبرغم أنه يعمل مع طرطوسي 5 عمال في معملها "الميني"، تصر في الكثير من الأحيان على العمل بيدها، وهذا ما يؤكد أن مهنتها لا تزال مصدر تسلية وإلهام لها.
في قلب السوق العتيقة في طرابلس حيث يمتزج صدى الحرف مع رائحة التاريخ، تجلس فاطمة طرطوسي أمام متجرها الصغير، تحيط بها الأواني النحاسية المنقوشة بدقة لا توصف. المطرقة التي تحملها في يدها وتستخدمها لنقش النقوش ليست مجرد أداة، بل امتداد لذاكرة عمرها أكثر من قرن. هي ليست فقط صانعة نحاس، بل حارسة مهنة توارثتها عن أجدادها.
"عند التسع سنوات قررت البقاء في هذا المصنع مع أهلي"، تقول وهي تمسح العرق عن جبينها وتتابع النقش بحذر شديد. ورثت طرطوسي المهنة عن والدها، الذي ورثها بدوره عن والده. في عائلتها، لم يكن النحاس حرفةً للرجال فحسب، بل كان إرثاً تتناقله الأيادي المؤمنة بأهميته، نساءً ورجالاً على حدّ سواء.
حياكة النول
تراث عريق من الشوف إلى العالم
فرح نصور

وتؤكد أن للعمل اليدوي قيمةً أسمى من عمل الآلات، ، فهو يستغرق وقتاً أطول لإنجازه، و"أحياناً نستمر في حياكة قطعة واحدة شهرين، وما ينتجه النول اليدوي من المستحيل أن ينتجه النول الكهربائي أو الآلات، وخصوصاً النقشات والرسوم".
بلغت فياض من الخبرة درجةً تخوّلها إبداع رسوم المنسوجات ارتجالياً على النول من دون سابق تخطيط. وكان لوالدها الفضل في إيصال هذا التراث إلى العالمية، فهو طوّرها بنقشات وأقمشة وخيوط جديدة. وفي عام 2000، حازت عباءة من عباءاته جائزة اليونسكو في باريس في مجال الحرف اليدوية.
ورغم أنّ منطقة الشوف هي من أوائل المناطق التي حاكت النول في لبنان، لم يبقَ فيها سوى نول هناء اليوم. وقد وصلت منسوجات هناء ووالدها وعباءاتهما الى زعماء وأمراء وشخصيات مرموقة ورفيعة محلية وعالمية، مثل فيدال كاسترو، الفنان كاظم الساهر، أول رائدة فضاء روسية فالنتينا تيريشكوفا، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان. وتحتفظ هناء بصور لها في أرشيف العائلة.
وشهد منزلها على وفود رسمية وشعبية وسفراء عرب وأجانب وسيّاح وممثلين عن منظمات أممية، زاروا هذا البيت الحرفي الذي يعكس وجهاً من أوجه لبنان الجميلة وهو أحد أرصدة تراثه.
في بلدة بشتفين قضاء الشوف، وفي منزل يفوح منه عبق التراث، تحوك هناء فيّاض على النول الطراز الشرقي من الملبوسات، وهي حرفة عريقة وقديمة في طريقها إلى الانقراض في لبنان.
"تاريخ هذه الحرفة مشرِّف وعريق يفوق 130 عاماً في هذا البيت"، تقول فيّاض لـ"النهار". وهي ورثت هذه الحرفة من والدها، الذي بدوره ورثها من والده. في عمر الـ17 تقريباً، حاكت أول فستان ووشاح لها. بعد 10 سنوات، احترفت هذه المهنة وأصبحت المصدر الأساسي والوحيد لدخلها.
منذ أكثر من 35 عاماً، تحوك هناء فيّاض المنسوجات بحب يشعر به الداخل إلى مشغلها، وكأنّه مملكتها. تحرّك يديها وساقيها بإيقاع على النول، وهي تبذل مجهوداً غير بسيط. "حياكة النول تستنزف النظر وأعضاء الجسم، ولا سيما الذراعين والساقين والكتفين والظهر والرقبة والركبتين، إلى جانب المجهود الفكري في رسم التصميم ذهنياً وتنفيذه بالشكل الصحيح من دون أيّ دليل"، تروي.
تتمسّك فياض بهذه الحرفة "فهي شيء مقدّس في بيتنا، توارثتها أجيال وعاشت معها، أحببتها، تمسكت بها، وهي تمثّل فن بلدنا وتراثه ووجهاً من وجوه السياحة فيه".
الفخار والإبريق اللبناني
حرفة تروي تراثاً عمره قرون
فرح نصور

يلبّي ربيع طلبات زبائنه بأحجام فخار تصل إلى 50 أو 60 سنتيمتراً. وقد يصنع حوالى 50 أو 60 قطعة كبيرة وبحدود الـ 150 قطعة صغيرة من الفخار يومياً.
أصبح ربيع مقصداً لمحبي الفخار المحليين والأجانب. يأتونه ليتعرفوا إلى الطرق التقليدية لصنع الفخار، لا سيما التقنية الفريدة والخاصة التي تكتنزها هذه الحرفة (تقنية الدولاب). ويذكر ربيع أنّ في بيروت مشاغل فخار لكنّها لا تعتمد هذه التقنية التي يعتمدها هو و"هي الأصعب، وهي أساس الفخار، والحرفيون الذين يعتمدونها قليلون جداً في لبنان".
يتوزع إنتاج ربيع من الفخار بمختلف أشكاله وألوانه، على المطاعم اللبنانية المحلية، متاجر الحرف، المعارض الموسمية، وبعض السوبر ماركات. كما أنّ عودة الناس إلى الطبيعة، وإلى السياحة البيئية، شجّعت على استخدام الفخار، و"أتمنى أن تستمر هذه الحرفة لنحافظ على تراثنا".
كان ربيع ضو، صانع الفخار من قرية بشتفين قضاء الشوف، يقصد مشغل الفخار الخاص بأبيه عندما كان صغيراً، لاسيما في أيام العطلة الصيفية، و"انحفرت هذه الزيارات في ذاكرتي" يقول لـ"النهار"، حتى بعد تخرجه في الجامعة بتخصص إدارة الأعمال وتوليه وظيفة مدير مالي في إحدى الشركات لمدة 27 عاماً.
لا تزال صناعة الفخار موجودة في بلدات لبنانية عدة، وتعتبر من المهن المتوارثة المرتبطة بعادات الاستهلاك في القرون الماضية.
كان يصنع الفخار كهواية طيلة هذه السنوات. شاءت الظروف أن يترك ربيع وظيفته بعد انتشار جائحة كورونا وحلول الأزمة الاقتصادية في لبنان ليمتهن صناعة الفخار ويتفرغ لها كلياً. خصّص لها طبقة كاملة في منزله، وصنعها بشغف.
"صناعة الفخار هي حنين الطفولة بالنسبة إليّ وذكرى من والدي، وهي في الوقت نفسه تراث شعرت أنّ من مسؤوليتي الحفاظ عليه، كونه من أقدم الحرف ومهدّد بالانقراض"، بالنسبة إلى ربيع.
ما يميّز الفخار اللبناني، أنّه "حرفة يدوية مئة في المئة، بينما الفخار في دول أخرى تدخل في صناعته الآلات والقوالب. أيضاً، المادة التي يصنع منها الفخار في لبنان هي من تراب لبنان وهي ذات جودة أفضل من غيرها. ويساعد العمل اليدوي على تنويع الأشكال في الفخار بينما الفخار المصنوع في الآلات يأتي بأشكال وأحجام standard . وأشهر ما يميّز الفخار في لبنان، هو إبريق الفخار اللبناني، وهو الذي لا يمكن للآلات صناعته".
السكاكين الجزينية
تستلهم طائر الفينيق
أحمد منتش

تشير رزق إلى أن آل حداد "تنبهوا بعد هذه السكين الصغيرة إلى قوة المادة ومتانتها، ووجدوا أنها لا تتأثر بالرطوبة وعامل الزمن، فأرسلوا عيّنة من زجاج الطائرة إلى فرنسا، حيث أجري لها تحليل، فتبيّن أنها مادة "أسيتادو سيلليلوز"، ومن وقتها اعتمدت أساساً في هذه الصناعة".
كل قبضة سكين أو شوكة تمرّ بـ 11 مرحلة، وكل قطعة تتعاقب عليها 11 يداً. وفيها 73 قطعة من النحاس، ويجري تزيينها يدوياً. حتى الزخرفة الصغيرة التي لا تتعدى النصف سنتيمتر، من ورد ونقاط وعين، يجري حفرها وإدخالها في القطعة، لتصبح تحفة متكاملة، وفقاً لرزق.
وفي شرحها رمزية العصفور الذي يجري تصنيعه، تقول رزق: "له رمزية كبيرة. ثمة روايتان في شأنه: الأولى تقول إنه مستوحى من طائر الفينيق الأسطوري الذي يشبه لبنان، الذي لا يموت، والذي يحترق ثم ينهض من رماده ويعيش من جديد. أما الرواية الأخرى، فترجع إلى الحرب العالمية الأولى، إلى وقت المجاعة، عندما التهم الجراد الأخضر واليابس، حينها لم يجد العصفور الجائع ما يطعم صغاره، فصارت الأم تطعمهم من لحم صدرها. ومن هنا نرى دوماً منقار العصفور نازلاً على صدره، كرمز للتضحية والعطاء".
وتابعت: "أحد الحدادين استلهم هذه القصة، وابتدع أول موديل، وصار العصفور رمز جزين. وهو اليوم الهدية الرسمية باسم الدولة اللبنانية، وقد أُهدي إلى شخصيات عالمية مثل جاك شيراك، البابا بنديكتوس السادس عشر، كوفي عنان، أحمدي نجاد، رونالد ريغان، جون كينيدي، فيديل كاسترو، هوغو تشافيز، وميخائيل غورباتشوف. وأحد هذه النماذج، تحديداً الذي أُهدي إلى غورباتشوف، كانت قيمته عالية جداً لدرجة أنه صار معروضاً في متحف روسي".
وفي تحول واعٍ نحو الحفاظ على الحياة البرية العالمية، توقف الحرفيون الجزينيون عن استعمال العاج، علماً أن ثمة قطعتين قديمتين مطعمّتان بالعاج، ولهما مكانتان عظيمتان، الأولى موجودة في متحف إيراني كانت هدية للشاه، والأخرى سيف مصنّف بين أهم خمسين سيفاً في العالم، مصنوع في زمن العثمانيين، ومعروض اليوم في أحد المتاحف التركية.
تتميّز مدينة جزين "عروس الشلال"، في جنوبي لبنان، بموقعها الفريد بين غابات الصنوبر الغنّاء والجبال التي تعانق السماء على ارتفاعات تتخطى الـ1000 متر. لكن صناعاتها الشهيرة، من السكاكين والخناجر والسيوف المرصعة والمطعّمة، تضاهي شلالها تميّزاً، وقد وصلت شهرتها إلى آخر الكون.
يبدأ تاريخ حرفة السكاكين وما يتفرع منها، في جزين، عام 1770، مع آل حداد، الذين كانوا يمتهنون الحدادة. في ذلك الوقت، لم يكن منتشراً استعمال الملعقة والشوكة، فكانت مشغولاتهم تقتصر على صنع أدوات قتال مثل الخناجر والسيوف والبنادق، ويستخدمون لقبضاتها قرون الجاموس أو الماعز أو حتى عظام الخروف والعاج. ومع تطور الزمن، تحوّلوا إلى صناعة أدوات المائدة، وتوقفوا عن استخدام القرون، لأنها مادة طبيعية تمتص المياه وتفسد الطعام وتشكّل خطراً صحياً.
مع انتشار هذه المنتجات الصناعية الجزينية التي وصلت إلى العالمية، ولا سيّما السيوف المرصّعة بالذهب، التي كانت تمثّل أجمل الهدايا وأثمنها للملوك والرؤساء وزعماء العرب والعالم، فضلاً عن أنها تؤمن السيوف للضباط خريجي المدرسة الحربية، ارتفع عدد العاملين في المهنة ليشمل عائلات شاهين وعون وعبد النور ورحيّم وأبو راشد والعاقوري وقرداحي وغيرهم. ورغم التخوف من انقراض هذه المهنة، لا تزال محال أصحاب المهنة في سوق جزين التراثية شاهدة على صمودها رغم التحديات.
"النهار" استطلعت في جولة ميدانية في جزين أوضاع عدد من أصحاب هذه الحرفة والعاملين فيها، والذين هم على معرفة شاملة بكل تفاصيلها. وفي مشغل آل حداد ومتجرهم، في سوق السدّ التراثية، وهو الأعرق في تصنيع السكاكين والملاعق والشوك والخناجر والسيوف المزخرفة والمرصعة والملونة وبيعها، قالت المسؤولة عن المبيعات غريس رزق: "الصنعة بدأت سنة 1770 مع بيت حداد. وبعد استعمالهم المواد الطبيعية وتصنيعهم أدوات المائدة، توقفوا عن استخدام القرون، وبدؤوا استخدام مادة مميّزة اسمها Acetate cellulose ، وهي مزيج من بودرة الزجاج والخشب والقطن، وهي نفسها التي تُستخدم في صناعة زجاج الطائرات. إنها مادة صلبة لكنها في الوقت نفسه مرنة، وتسمح لنا بأن نبدع تحفاً فنية تليق باسم جزين".
ولفتت إلى "أن اكتشاف مادة الـ Acetate cellulose صار مصادفة. ففيما كان الإنكليز والفرنسيون يتحاربون في منطقة جزين، سقطت طائرة في وادي جزين، وهرع الأولاد ليتفقدوا الحطام. وقتها، كان سمير حداد، وهو من الجيل الرابع لعائلة الحدادين، ويُعرف بـ"شيخ الحرفيين"، في الثامنة من عمره. أخذ زجاج الطائرة، وراح يشتغل عليه في القبو، وصنع منه سكيناً صغيرة. لما صار عمره 14 سنة، أتت امرأة إنكليزية، واشترت منه السكين بخمسين ليرة، وكان مبلغاً هائلاً وقتها".
صابون "الشركس" في طرابلس
منذ 1803 بالطريقة نفسها
جاد فقيه

وبعد وصوله إلى طرابلس، لم يتقبّله أبناء المدينة لكونه غريباً، و"لم يستطع إثبات نفسه في السوق سوى بعد ابتكاره الصابونة المدورة الغريبة على الناس آنذاك، وإلى الآن أنا أصنع منها"، وفق الشركس.
وعن استمرارية هذه المهنة يلفت إلى أنه ينتمي إلى الجيل التاسع في المعمل نفسه ويسعى دائماً إلى تطوير المصلحة مع الحفاظ على الجودة والمكوّنات الطبيعية، وهذا ما يميّزنا عن البضاعة المستوردة، لذلك لا يزال الناس يقصدوننا، فضلاً عن أن أسعارنا لا تزال معقولة، فالصابونة الواحدة لا يتعدّى سعرها الدولار الواحد، وهامش ربحنا منخفض جداً، والاستفادة تكون حين نصدّر إلى خارج لبنان".
ولا يزال السياح والمغتربون الوافدون يقصدون المعمل، إذ "نعمل ونصمّم شكل الصابون باليد ومن دون إدخال أي آلة، وهذا ما أذكره منذ أن كنت في عمر الـ8 سنوات، وهو العمر الذي تركتُ فيه المدرسة لتعلم هذه المصلحة التي سأعلمها لولدي إذا رغب في ذلك".
لا يزال العشريني أحمد الشركس يتخذ من أسواق طرابلس القديمة مركزاً لمصنع الصابون الذي يملكه، وهو من أقدم المصانع في لبنان.
امتهن الأخير هذه المهنة التي ورثها عن أجداده ولا يزال وفيّاً للطريقة التي كان يستخدمها جدّه المؤسس منذ أكثر من 200 سنة اعتماداً على زيت الزيتون المكوّن الرئيسي للمادة النهائية.
يقف أحمد تحت صور جدّه وأبيه ليروي لنا بشغف عن تاريخ معمله فيقول: "هذا المعمل تأسس سنة 1803، وجدّي المؤسس كان يصنع الصابون في روسيا قبل هذا التاريخ، لكن تزامناً مع الحرب على القبائل الشركسية في مطلع القرن التاسع عشر هُجّر كغيره إلى لبنان، وتحديداً إلى طرابلس حيث أسّس هذا المصنع".
"القشاش" يحفظ مهنة الأجداد
ويجذب السياح
أحمد منتش

يؤكد كوسا أن الطلب على كرسي القش أو النايلون الملون لا يزال قائماً، خصوصاً في الصالات والمقاهي، بل البعض يقتنيها كتحفة تراثية في منزله، أو يضعها على طاولة السفرة، فيما بعض السيّاح الأجانب يعرجون على مشغله، إما لشراء قطعة صغيرة وإما للمشاهدة والتقاط الصور.
ويشدّد كوسا على أهمية ومتانة الكرسي الخشبي المصنوع من شجر الحور أو السرو، والذي يمكن أن يخدم صاحبه لعدة عقود، مشيراً إلى سهولة إعادة ترميمه وإصلاحه بكلفة زهيدة، خلافاً لكرسي البلاستيك الرديء الذي غزا السوق، والذي يبقى عرضة للكسر والتلف.
تقشيش الكراسي الخشبية حرفة يدوية تعلّمها عدد من أبناء مدينة صيدا، منذ زمن السلطنة العثمانية؛ وحتى يومنا هذا لا تزال هذه الصناعة رائجة، رغم أن عدد ممتهني هذه الحرفة لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.
يواظب سهيل كوسا (أبو عمر) على العمل في هذه الصناعة اليدوية التراثية، في مشغله المؤلف من محلّين صغيرين، عند الواجهة البحرية، قبالة مدخل مرفأ صيدا وميناء الصيادين، علماً بأن أحد المحلّين لا يزال متصدّع السقف منذ فترة الاحتلال الإسرائيلي لمدينة صيدا عام 1982.
تتصدّر واجهة المحلّين على رصيف الطريق العامة كمية من الكراسي من عدة أشكال وأحجام، منها بالقش وآخر بالنايلون المضغوط وبألوان عدة.
ويقول أبو عمر إنه أدخل النايلون الملوّن على الكرسي بدلاً من القشّ، لأن الصغار يفضّلونه ويرغبون فيه. وإلى جانب الكراسي الخشبية، نجد أيضاً أشكالاً مختلفة ومتنوعة من السلاسل والخيم والستائر المصنوعة يدوياً من القصب، أضافها أبو عمر إلى صناعة الكراسي، لحاجة السوق المحلية إليها، وكي يستطيع الحفاظ على عمله الأحبّ إلى قلبه في تقشيش الكراسي كصناعة ورثها عن والده، ويأمل في توريثها لأحد أولاده.